 |
| جديد المواضيع |

| للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
| منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|||||||
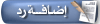 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#41
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم >جزاك الله خيرا يا جند بيت المقدس
|
|
#42
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الــتــتــرس في الجهاد المعاصر تأليف الشيخ حسن محمد قائد (أبي يحيى الليبي) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد... فهذه المسألة تعتبر من أمهات المسائل التي تعترض المجاهدين اليوم، ومن ملمات العصر وكبرى قضاياه التي تُذكر كلما ذكر الجهاد، ولا يخفى أن كثرة تداول المسألة وترديدها على الألسن والكتابات؛ يشير إلى أهميتها، ويدل على قوة طرحها وشدة الحاجة إلى معالجتها، وهذا هو واقع هذه المسألة المثارة. ولا يجوز شرعاً ولا عقلاً غض الطرف عما عمت الحاجة إليه، ودل الواقع على الإلحاح فيه، بل لا بد من إمعان النظر وتقليب الفِكَر والاتجاه لمنبع الحق ونور الهدى للاسترشاد ونيل الرشاد. فهذه المسألة مع جريان بحثها اليوم مجرى الحاجة بل الضرورة في كثير من الأحيان فهي - فيما أعلم واطلعت - لم تعط حقها من التحقيق ودقة النظر، ولم تنل حظها كاملاً بالبحث والتبيين، وما أحوجها له. ولا أزعم أني سأفعل ذلك، ولكن حسبي المشاركة مع من كتب فيها من قبلُ، وإعادة إثارتها والتأكيد على ضرورة بحثها وبيان تفاصيل أحكامها لمن قدر على ذلك وتهيأت له الأسباب والظروف، فحالها - في الكثير المشاع - بين مثبت لجواز الأمر بعمومات وإطلاقات ونقولات وقواعد كلية نُزِّلت منزلة الأدلة الشرعية التفصيلية، وبين ناف ومانع ومتحرج من غير نزول إلى حقيقة الواقع وإشكالات العمل ومتطلبات الساحات وتفاصيل الأمور. فربما أدى إطلاق الأولين؛ إلى التهاون في كثير من الدماء المعصومة، وقاد إلى ضعف الوازع الديني ونزع الهيبة القلبية التي يشعر بها كل مسلم سويٍّ تجاه الدماء المحرمة، كما قد يؤدي إحجام الآخرين التام وتحرجهم المطلق؛ إلى تعطيل الجهاد تعطيلاً كاملاً، أو القيام بأعمال جزئية مغمورة لا تؤدي المقصود ولا تلبي المطلوب. فنسأل الله أن يُلهمنا رشدنا ويسدد أقوالنا وأقلامنا، وأن يدلنا على طريق الحق حتى نصيبه، ويُبصِّرنا بمزالق الحيف حتى نبتعد عنه إنه سميع مجيب. القضية الأولى في ذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة في التغليظ والتشديد في سفك دم المسلم بغير حق قال الله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء: 93]، وقال سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً} [النساء: 29 – 30]، وقال سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً} [الفرقان68 - 69، وقال عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً} [النساء: 92]. وأما السنة... فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات)، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق... الحديث)( ). والموبقات؛ أي المهلكات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً). وقال ابن عمر رضي الله عنهما: (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها؛ سفك الدم الحرام بغير حله)( ). والورطات؛ جمع ورطة بسكون الراء، وهي الهلكة وكل أمر تعسر النجاة منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم)( ). وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً، أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً)( ). وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله، لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)( ). ثم روى عن خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: (فاغتبط بقتله)، قال: (الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم، فيرى أحدهم أنه على هدى لا يستغفر الله). والصرف: النافلة، والعدل: الفريضة، وقيل غير ذلك. والأحاديث في هذا الباب والتي تشدد في حرمة دم المسلم وتحذر أشد التحذير من انتهاكها والجرأة عليها؛ لا تكاد تحصى، وفيما ذكرنا كفاية وغنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وتعظيم هذا في القلوب وتفخيمه في النفوس هو شأن كل مسلم سوي يُراقب الله في كل ما يأتي ويذر. وللمزيد يراجع في ذلك كتاب "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري رحمه الله، تحت باب: "الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق"، فقد ساق فيها من الأحاديث الصحيحة الزاجرة ما يملأ قلب المؤمن خشية ورهبة من الإقدام على هتك هذا الستر الغليظ، إلا حيث كان البرهان ساطعاً قاطعاً كالشمس في رابعة النهار ليس دونها حجاب. فحري بكل مؤمن يخاف على نفسه ويحرص على دينه؛ أن يبحث عن الحق بحثاً حثيثاً، وأن يتحراه تحرياً وافياً، وأن يطرد عن نفسه وقلبه شوائب الهوى، ويتجنب مسالك الردى، وأن يأوي فيما يقول ويفعل إلى ركن شديد ونهج رشيد من الحق والحجة، تغنيه وتكفيه جواباً حينما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسأله - وهو عالم بحاله ودخيلة صدره -؛ "فيم قتلت فلاناً؟". القضية الثانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)( ). وما جاء في هذا الحديث من ذكر الحالات التي يباح فيها دم المسلم؛ هو بعض ما جاء مستثنى في آيات متعددة متكررة ناهية عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام: 151]، وغيرها من الآيات. إلا أن القتل الجائز شرعاً ليس محصوراً في الصور الثلاث التي وردت في الحديث المذكور، ولهذا فإن العلماء اختلفوا اختلافاً كثيراً وتنوعت وجهاتهم في الجمع بين دلالة هذا الحديث الصريحة في أن دم المسلم لا يباح إلا بواحدة من الحالات الثلاث وبين الأحاديث والآيات الأخرى التي نصت أو أشارت إلى إباحة دم المسلم في غيرها. - كإباحة قتال طائفة البغاة المنصوص عليها في قول الله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9]. - وكقتال وقتل قطاع الطريق المسلمين المذكور حكمهم في قوله عزو وجل: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33]. - وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخر منهما)( ). - وله من رواية عرفجة: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، فأراد أن يشق عصاكم أويفرق جماعتكم فاقتلوه). ونظير هذا عدة أحاديث تُبيح دم المسلم في غير الحالات الثلاث التي وردت في حديث ابن مسعود المذكور، وإن كان الأخذ بمقتضاها ليس متفقاً عليه بين العلماء. وليس المطلب الآن هو تتبع أقوال الأئمة واستقصاء طرائقهم في الجمع بين هذه الأحاديث، فالموطن موطن اختصار، وإنما المقصود فقط الإشارة إلى أن مواضع الإباحة الواردة في حديث ابن مسعود ليست حصراً لصورها إذا ما انضم إليها غيرها من الآيات والأحاديث كالتي ذكرت بعضها. القضية الثالثة ثمة مسألة طرحها الفقهاء كثيراً وناقشوها وفصَّلوا أحوالها ونوَّعوا صورها واستوعبوا أحكامها في كتب الفقه والتفسير، تبعاً لوقوعها في أزمانهم وتجاذب أطرافها وقيام موجبها بينهم. وهي ما تعرف بمسألة "التترس". وحيث أن الفقهاء الأولين الراسخين لم يُهملوا هذه المسألة ولم يضربوا عنها صفحاً؛ كان ذلك منة من الله على الآخرين اللاحقين ليتتبعوا آثارهم ويحققوا أدلتهم ويفهموا حججهم وبيناتهم، {ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ} [يوسف: 38]. فتسمية هذه المسألة أصالة مأخوذ من "الترس"، وهو الآلة الحربية المعروفة التي يقي بها المقاتل نفسه من ضربات عدوه ورميه وطعنه، وهو من عدة الحرب. ومنه حديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: (كان أبو طلحةَ يَتَتَرَّسُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتُرْسٍ واحد). فالكفار قد يتخذون من بأيدهم من الأسرى المسلمين والذميين "تُرساً"، يردون بهم هجوم جيش المسلمين عليهم ويتقونهم به، حيث يجعلونهم في مواضع وأماكن لا يمكن لجيش المسلمين الوصول إليهم والنيل منهم إلا بقتل وإصابة من بأيديهم من الأسارى، فيكون ذلك مانعاً للجيوش الإسلامية من الإقدام، ورادعاً لهم عن الهجوم والرمي، إذ إن إحجام المسلم عن قتل أخيه والتردد في ذلك مغروس في قلبه، بل هو دأب كل أحدٍ مع بني قومه - كما هو مشاهد – وكذا الحال مع مَن هو في ذمتهم. إذاً فهذه الصورة واردة بلا ريب، وغالباً ما أثارها الفقهاء إلا لوقوعها أو قوة توقعها، ولهذا لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه من ذكرها وإتباعها لأحكام الجهاد. وهي بهذه الكيفية المخصوصة التي يصورها بها الفقهاء؛ لم أر لها ذكراً في الأحاديث النبوية ولا في سيرة الصحابة القتالية، مما يقوي القول بأنها من النوازل التي طرأت لاحقاً وبعد توسع رقعة الدولة الإسلامية. وعلى كل حال فبتتبع الصور التي ذكرها الفقهاء لمسألة التترس، يظهر أن لها حالتين: - الحالة الأولى؛ حالة اضطرارية وهي التي يُتخذ فيها الأُسارى المسلمون أو مَن حرُمت دماؤهم من الكافرين ترساً: بحيث يكون هؤلاء الأسارى مجبرين على ذلك ولا اختيار لهم في البقاء بين أظهر الكافرين، ولا حيلة لهم في اتقاء رمي إخوانهم المسلمين، فالذين يأسرونهم يتعمدون وضعهم في مكان ما، بغية رد هجمات المسلمين عن أنفسهم واتقائهم ذلك بأسراهم. - الحالة الثانية؛ أن يكون ضمن حصن من حصون الكافرين أو قلعة من قلاعهم بعض المسلمين من التجار أو من أسلم ولم يهاجر أو غيرهم: بحيث يكون وجودهم في ذلك الموطن وبقاؤهم فيه؛ اختيارياً، بمعنى أن الكفار لم يقصدوا اتخاذ من هو بينهم من المسلمين ترساً يتقون به هجمات وضربات جيوش المسلمين، وإنما وقع وجود التجار المسلمين ونحوهم بين الكافرين اتفاقاً، إلا أن رمي الكفار بما يعم يؤدي قطعاً أو بغلبة الظن؛ إلى إصابة أو قتل من يوجد بينهم من المسلمين. وهذه الصورة أكثر وقوعاً في جهاد الطلب. فعلاقة الحالة الأولى بأصل التسمية - "الترس" - ألصق وأوثق وأوضح من الحالة الثانية، لأن آلة الحرب الذي هو الترس، إنما يكون في يد المُتقي به، وهو الذي يحركه ويوجهه حيثما رأى الخطر يداهمه، ليدفعه به ويرده عن نفسه. وأما في الحالة الثانية؛ فوجه التسمية أن المجاهدين حينما يعلمون بوجود مسلمين في حصون وقلاع ومراكز الكافرين فإن ذلك يدفعهم عادة إلى التوقف عن الرمي بما يعم الكافرين وغيرهم، فبهذا الاعتبار كأن المسلمين المقيمين وَقَوا الكافرين هجمات المجاهدين ورميهم، وإن لم يقصدوا ذلك، فصاروا في حكم الترس لهم بجامع أن اتخاذه إنما هو لاتقاء الضرب والطعن والرمي، ووجودهم قد قاد إلى ذلك وساق إليه. وسننقل بعض أقوال العلماء فيما بعد - إن شاء الله - وكثير منها مشتمل في ثناياه على ذكر الحالتين. إلا أننا سنشير إلى بعضها باختصار هنا، بما يتم به تصور المسألة وارتسامها: قال الإمام الجصاص رحمه الله: (قال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين، وإن كان فيها أسارى وأطفال من المسلمين، ولا بأس بأن يحرقوا الحصون ويقصدوا به المشركين، وكذلك إن تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون)( ). وقال أيضاً: (وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الإقدام على الكفار، مع العلم بكون المسلمين بين أظهرهم، وجب جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين، لأن القصد في الحالين رمي المشركين دونهم)( ). وقال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله - وقد حوى كلامه ذكر الحالتين -: (ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى أوالتجار... إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر... وكذا إذا تترسوا باطفال المسلمين؛ فلا بأس بالرمي إليهم)( ). وقال الإمام الشافعي رحمه الله - ذاكراً للصورتين -: (فإن كان في الدار أسارى من المسلمين أو تجار مستأمنون؛ كرهت النصب عليهم بما يعم من التحريق والتغريق وما أشبهه... ولو تترسوا بمسلم؛ رأيت أن يكف عمن تترسوا به، إلا أن يكون المسلمون ملتحمين...)( ). وقال الإمام الماوردي رحمه الله: (ولو كان في دراهم مسلم، ولم يتترسوا به؛ جاز رميهم، بخلاف لو تترسوا به، لأنهم إذا تترسوا به كان مقصوداً، وإذا لم يتترسوا به فهو غير مقصود...)( ). القضية الرابعة وهي في بيان مجمل الأدلة التي اعتمد عليها العلماء في جواز ضرب الترس من المسلمين، أو الذميين أو رمي الحصون والقلاع التي يختلط فيها الكافرون بالمسلمين بغض النظر عن ترجيحاتهم في ذلك، ومن غير تعرض لتفاصيل صور تنزيلها الدليل الأول؛ الإجماع: نقل بعض الأئمة الاتفاق على جواز رمي الترس إذا خيف على المسلمين ضرر عند عدم الرمي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: (:فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يُقاتلوا، فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار)( ). وقال أيضاً: (وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم)( ). وقال أيضاً: (ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يُفضي إلى قتل أولئك المُتترس بهم جاز ذلك)( ). فحالة الاتفاق التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله؛ مقصورة ومحصورة فيما لو خيف على المسلمين ضرر إن لم يُرم الكافرون، وإن أدى ذلك إلى قتل الترس تبعاً، ولم أر - فيما اطلعت - أحداً نقل الاتفاق على هذه الصورة سوى شيخ الإسلام رحمه الله، وهو من هو في الاستقصاء والتحري والتحقيق والتدقيق، إلا أن هذا الاتفاق - والله أعلم - محمول على حالة يكون فيها الضرر محققاً وقوعه على جماعة المسلمين. وهكذا جاء في "الموسوعة الفقهية": (يتّفق الفقهاء على أنّه إذا كان في ترك الرّمي خطرٌ محقّقٌ على جماعة المسلمين، فإنّه يجوز الرّمي برغم التّترّس، لأنّ في الرّمي دفع الضّرر العامّ بالذّبّ عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير ضررٌ خاصٌّ، ويقصد عند الرّمي الكفّار لا التّرس). ثم نبهني بعض الأخوة الأحبة إلى أن كلام القرطبي رحمه الله - والذي سيأتي بتمامه - قد يكون موافقاً لما نقله شيخ الإسلام من الإجماع، وإن لم يكن صريحاً في ذلك، حيث قال بعد ذكر بعض الضوابط والقيود التي يجب أن تكون متوافرة في حالة التترس، قال: (قلت: قد يجوز قتل الترس، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية). ورغم هذا الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله واشتهر عنه وتداوله الباحثون من بعده، إلا أن هناك وجهاً عند بعض الشافعية بعدم جواز رمي الترس حتى في حال الاضطرار، ولعله بسبب ضعف هذا القول وانغماره لم يعتدَّ به من نقل الإجماع ولم يعتبره شيئاً يُنظر إليه على أنه خرق له، أو أنه محمول على ما إذا لم يكن الخوف على جماعة المسلمين وعامتهم وإنما على بعضهم مع إمكانية الكف عن الكفار. وعلى هذه الصورة حملوها في "الموسوعة الفقهية" إذ جاء فيها: (أمّا في حالة خوف وقوع الضّرر على أكثر المسلمين؛ فكذلك يجوز رميهم عند جمهور الفقهاء، لأنّها حالة ضرورةٍ أيضاً، وتسقط حرمة التّرس، ويقول الصّاويّ المالكيّ: "ولو كان المسلمون المتترّس بهم أكثر من المجاهدين"، وفي وجهٍ عند الشّافعيّة؛ لا يجوز، وعلّلوه بأنّ مجرّد الخوف لا يبيح الدّم المعصوم). قال الإمام النووي رحمه الله في بيان وجه ذلك عند الشافعية: (وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال، وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم، فوجهان؛ أحدهما، لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلم، لأن غايته أن نخاف على أنفسنا، ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه، والثاني - وهو الصحيح المنصوص، وبه قطع العراقيون - جواز الرمي على قصد قتال المشركين، ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان)( ). ومن المعلوم أصولياً؛ أن الإجماع - وإن كان حجة شرعية - إلا أنه لا يُتصور ولا يمكن أن ينعقد إلا ويكون مستنداً لدليل من الكتاب أو السنة أو القياس. وذلك المستند الذي يرجع إليه قد يطلع عليه بعض الفقهاء ويدركه ويصل إليه وقد يغيب عن غيرهم، إلا أنه لا يمكن أن يخفى على جميعهم، لأن الدين اكتمل، والشريعة تمت، وإحداث حكم شرعي استقلالاً من غير رجوع إلى أحد الأصلين يُعد تشريعاً واجتماعاً على ضلالة، والأمة بمجموعها معصومة عن ذلك. ومع هذا، فمع تحقق صحة الإجماع وثبوته، فلا يلزم المفتي أو العالم البحث عن مستنده إلا من جهة تقوية الدليل وعَضْدِ الحجة. قال الشيرازي الشافعي: (اعلم؛ أن الإجماع لا ينعقد إلا على دليل، فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم، سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه، ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به الحكم، كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب والسنة وفحواهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره والقياس)( ). وإنما ذكَّرت بهذه القاعدة الأصولية في هذا الموضع لنستصحبها عند ذكر بعض الأدلة اللاحقة التي اعتمد عليها الفقهاء في تقرير هذا الحكم، والتي قد تكون بأفرادها وأعيانها أو بمجموعها هي مستند الإجماع ومعتمده. الدليل الثاني؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، مع أن فيه نساءهم وأطفالهم، ومثل هذا يعم به القتل غالباً: وكذلك جرت عادة قادة المسلمين وجيوشهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم بنصب المجانيق على الحصون ورميها بها، مع العلم بوجود من لا يحل قصد قتله من النساء والولدان وغيرهم. قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله في مناقشته الأوزاعي: (ولوكان يحرم رمي المشركين وقتالهم إذا كان معهم أطفال المسلمين؛ لحرم ذلك أيضا منهم إذا كان معهم أطفالهم ونساؤهم، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والصبيان، وقد حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وأهل خيبر وقريظة والنضير وأجلب المسلمون عليهم فيما بلغنا أشد ما قدروا عليه، وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق، فلو كان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لِنَهْي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لم يقاتلوا، لأن مدائنهم وحصونهم لا تخلو من الأطفال والكبير الفاني والصغير والأسير والتاجر، وهذا من أمر الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حصون الأعاجم قبلنا على ذلك، لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برمي ولا غيره من القوة لمكان النساء والصبيان ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم)( ). فأما حصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف؛ فهو في الصحيحين، وأما رميهم بمالمنجنيق؛ فقد رواه أبو داود في المراسيل عن ثور عن مكحول: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب على أهل الطائف المنجنيق). قال الحافظ ابن حجر: (ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولاً، ذكره معضلاً عن ثور، وروى أبو داود من مرسل يحيى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله شهراً، قال الأوزاعي فقلت ليحيى: أبلغك أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك وقال: ما نعرف ما هذا! وروى أبو داود في السنن من طريقين أنه حاصرهم بضع عشرة ليلة، قال السهيلي: ذكره الواقدي كما ذكره مكحول)( ). وقال الإمام الجصاص الحنفي رحمه الله مستدلاً بأثر مكحول المذكور: (نقل أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق، مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان، وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه قد يصيبهم وهو لا يجوِّز تعمدَ[هم] بالقتل، فدل على أن كون المسلمين فيما بين أهل الحرب لا يمنع رميهم، إذ كان القصد فيه المشركين دونهم)( ). فكما يظهر في كلام الإمامين أبي يوسف والجصاص؛ فإن الاستدلال بقصة رمي الطائف بالمنجنيق مركب من جزئين ومرتب على مقدمتين: الأولى؛ إثبات صحة الأثر، ومن ثَم الاستدلال به على جواز رمي الحصون التي تضم نساء وأطفال المشركين مع العلم بوجودهم بينهم. والثانية؛ صحة قياس وإلحاق المسلم في ذلك الحكم بنساء وذراري المشركين، بجامع أن الجميع معصومو الدماء شرعاً، وإن كانت درجة العصمة وشدتها متفاوتة، فكما هو معلوم مجزوم به فإن حرمة المسلم أعظم وأفخم. فالأثر - كما رأينا - مرسل، ومع اشتهاره وكثرة استدلال الفقهاء به وتدوالهم له واعتمادهم عليه في بعض من الأحكام لا يبعد أن يكون له أصل، لا سيما مع وجود بعض الأدلة التي تشاركه في أصل الحكم كالتي وردت في جواز البيات. وكما ذكرنا عن الإمام أبي يوسف؛ فإن سيرة الصحابة ومن بعدهم قادة الفتوحات قد جرت على ذلك، ولا بد أن يكون لهم في المسألة أثارة من علم، وثمة آثار متعددة عنهم في استعمالهم المجانيق لرمي حصون الكفار مع وجود نسائهم وأطفالهم فيها. بل نقل بعض العلماء اتفاق الفقهاء في الجملة على جواز رمي حصون الكفار، وإن كان فيها نساؤهم وأطفالهم خاصة، مستدلين بقصة الطائف المذكورة. كما قال ابن رشد رحمه الله: (واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق، سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن، لما جاء؛ أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف)( ). وعلى كل حال فإذا صح هذا الاتفاق؛ فإنه يغني عن الرجوع إلى أثر محكول والاعتماد عليه استقلالاً. ويبقى السؤال ما مدى صحة قياس حصن به أسارى وأطفال وتجار مسلمون؛ على حصن فيه نساء وأطفال الكفار في جواز رمي الجميع بالمنجنيق أو ما شاكله مما يعم به الهلاك؟ فقد ارتضى بعض الأئمة هذا القياس واستدل به ورفضه بعضهم. والمقصود هنا فقط؛ ذكر الأدلة التي يعتمد عليها الفقهاء في مسألة التترس، من غير التفات إلى ترجيح وتصحيح. الدليل الثالث: الأحاديث التي وردت في جواز البيات قولاً وفعلاً، وهو الإغارة على العدو ليلاً، مع العلم أن بين الكفار نساءهم وأطفالهم ومن لا يجوز قتله منهم ممن قد يصيبهم القتل تبعاً. - فعن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سُئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: (هم منهم)( ). - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال: (أغر على أُبنى صباحاً وحرِّق)( ). - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه، فغزونا ناسا من المشركين، فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة: أمت، أمت)، قال سلمة: (فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين)( ). قال الإمام أبو بكر الجصاص بعد ذكر بعض هذه الأحاديث: (وكان - أي النبي صلى الله عليه وسلم - يأمر السرايا بأن ينتظروا بمن يغزونهم، فإن أذنوا للصلاة أمسكوا عنهم، وإن لم يسمعوا أذاناً أغاروا، وعلى ذلك مضى الخلفاء الراشدون، ومعلوم أن من أغار على هؤلاء لا يخلو من أن يصيب من ذراريهم ونسائهم المحظور قتلهم، فكذلك إذا كان فيهم مسلمون وجب أن لا يمنع ذلك من شن الغارة عليهم ورميهم بالنشاب وغيره، وإن خيف عليه إصابة المسلم)( ). الدليل الرابع: تجويز رمي المشركين المتترسين بالمسلمين؛ قياسا على جواز ذلك في رمي حصونهم بالمجانيق وإن كان بينهم مسلمون - كتجار وأسارى ونحوهم – وفي هذا يقول الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله: (وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الإقدام على الكفار مع العلم بكون المسلمين بين أظهرهم؛ وجب جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين، لأن القصد في الحالين رمي المشركين دونهم)( ). الدليل الخامس: دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما، أو دفع الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص، وهي قاعدة مُتفق عليها بين العلماء، وإن وقع الاختلاف في تنزيلها على بعض جزئياتها. والمفسدة العظمى المدفوعة هنا؛ هي الفتنة والضرر والفساد الكبير المترتب على ترك الجهاد في سبيل الله لأجل ما بأيدي الكفار من الأسرى أو ما بينهم من التجار ونحوهم، فالأمر دائر بين الضرورة والحاجة، وفي الحالتين إنما هو دفع لأكبر المفسدتين بارتكاب أدناهما. فالأول؛ حيثما يكون الجهاد متعيناً بمداهمة الكفار لديار الإسلام، حيث يقع الضرر العظيم على المسلمين بتركه، إذ يفضي ذلك إلى تسلط الكافرين وإفسادهم للدين والدينا، كما قال تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: 191]، وقال عز وجل: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: 217]. والثاني؛ حيث لم يبلغ مرتبة الاضطرار، وذلك حينما يكون الجهاد جهاد طلب، فإن تركه لأجل من يُقيم بينهم من النساء والذرية والتجار والأسارى؛ يؤدي إلى تعطيل الجهاد المأمور به شرعاً، لا سيما إذا علم الكفار أن ذلك يكف المسلمين عنهم، فربما ارتكبوه تعمداً وقصداً؛ تلافياً لهجوم المسلمين عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وكذلك في باب الجهاد، وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراماً، فمتى احتيج الى قتال قد يعمهم مثل الرمى بالمنجنيق والتبييت بالليل؛ جاز ذلك، كما جاءت فيها السنة فى حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق، وفى أهل الدار من المشركين يبيتون، وهو دفع لفساد الفتنة أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله، وكذلك مسألة التترس التى ذكرها الفقهاء، فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر؛ فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي الى قتل اولئك المتترس بهم؛ جاز ذلك، وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد الا بما يفضي إلى قتلهم؛ ففيه قولان، ومن يُسوغ ذلك يقول؛ قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء)( ). وقال رحمه الله أيضاً: (ولا ريب أن العقوبة إذا أمكن أن لا يتعدى بها الجاني كان ذلك هو الواجب، ومع هذا فإذا كان الفساد في ترك عقوبة الجاني أعظم من الفساد في عقوبة من لم يجن؛ دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق، مع أن المنجنيق قد يصيب النساء والصبيان، وفي الصحيحين؛ أن الصعب بن جثامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم؟ فقال: "هم منهم"، ولو صالت المرأة الحامل على النفوس والأموال المعصومة فلم يندفع صيالها إلا بقتلها؛ قُتلت وإن قتل جنينها)( ). وقال أيضاً: (وقد روى مسلم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ قصة أصحاب الأخدود، وفيها؛ أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم فى صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان فى ذلك مصلحة للمسلمين... فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره، كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذى لا يندفع إلا بذلك؛ أولى)( ). وقال أيضاً: (فإن الأئمة متفقون؛ على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين، وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا، فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف على المسلمين؛ جاز رمى أولئك المسلمين أيضاً فى أحد قولي العلماء، ومن قتل لأجل الجهاد الذى أمر الله به ورسوله - وهو فى الباطن مظلوم - كان شهيداً وبُعث على نيته، ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين، وإذا كان الجهاد واجباً - وإن قتل من المسلمين ما شاء الله، فقتل من يقتل فى صفهم [أي في صف الكفار] من المسلمين لحاجة الجهاد؛ ليس أعظم من هذا)( ). وقال الإمام السرخسي: (وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمين؛ فلا بأس بالرمي إليهم وإن كان الرامي يعلم أنه يصيب المسلم... نقول: القتال معهم فرض، وإذا تركنا ذلك لما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم، ولأنه يتضرر المسلمون بذلك، فإنهم يمتنعون من الرمي لما أنهم تترسوا بأطفال المسلمين؛ فيجترؤن بذلك على المسلمين، وربما يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين، والضرر مدفوع)( ). وفي "الهداية"( ): (ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص، ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم، فلو امتنع باعتباره لانسد بابه، وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى؛ لم يكفوا عن رميهم لما بينا). وقال العبادي الحنفي: (قوله: "ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر": يعني يرميهم بالنشاب والحجارة والمنجنيق؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن جماعة المسلمين، وقتل التاجر والأسير ضرر خاص)( ). وقال الإمام النووي - وهو يعدد أقول مذهب الشافعية في المسألة -: (الثاني؛ وهو الصحيح المنصوص، وبه قطع العراقيون؛ جواز الرمي على قصد قتال المشركين، ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان، لأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام، ولا يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكليات)( ). وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي: ("وإن كان فيهم مسلم"؛ واحد فأكثر، "أسير أو تاجر جاز ذلك"؛ أي إحصارهم وقتلهم بما يعم، وتبييتهم في غفلة، وإن علم قتل المسلم بذلك، لكن يجب توقيه ما أمكن، "على المذهب"؛ لئلا يعطلوا الجهاد علينا بحبس مسلم عندهم)( ). وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (وإن تترسوا بأسارى المسلمين أو أهل الذمة؛ لم يجز رميهم إلا في حال التحام الحرب والخوف على المسلمين، لأنهم معصومون لأنفسهم، فلم يبح التعرض لإتلافهم ضرورة، وفي حال الضرورة؛ يُباح رميهم لأن حفظ الجيش أهم)( ). القضية الخامسة في بيان حقيقة الضرر الذي جوَّز الفقهاء لأجله ضرب الترس المسلم أو رمي الحصن الذي يوجد فيه مسلمون فإذا تأملنا في كلامهم حول السبب الذي أجازوا به رمي الكفار مع تترسهم بالمسلمين مما قد يؤدي إلى قتلهم؛ لرأينا أن مدار ذلك على دفع الضرر المتوقع حصوله إن لم يقم المجاهدون بذلك. بل نص شيخ الإسلام - كما رأينا سابقا - أن الرمي في مثل هذه الحالة هو موضع اتفاق بين الأئمة، وإن أدى ذلك إلى قتل المسلمين المتترَس بهم، فلا بد أن يكون للضرر المذكور والمعلل به الحكم؛ معنى واضح ومحدد قصده هؤلاء الأئمة وإن تعددت عباراتهم في التعبير عن ذلك - كما سنراه - وهو ما سنحاول أن نستخلصه من أقوالهم في هذه الفقرة. فمن ذلك؛ استيلاء الكفار على المسلمين وسيطرتهم على ديارهم: ولا شك أن هذه هي أم المفاسد ومصدر شرورها، فمنها يتفرع ما يذكره الفقهاء من المفاسد التفصيلية والطوام الفرعية الأخرى، والتي لا يتصور وقوعها بشمول واتساع إلا حيث كانت الأمور بيد الكفار والغلبة لهم ومقاليد البلاد في قبضتهم، فيُقيمون ما أرادوا ويقصون ما شاءوا. وذي هي بعض أقوال الفقهاء ونصوصهم في ذلك: قال الإمام القرطبي رحمه الله: (قلت: قد يجوز قتل الترس، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، فمعنى كونها ضرورية؛ أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية؛ أنها قاطعة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة، ومعنى كونها قطعية؛ أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا، قال علماؤنا؛ وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو؛ فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين، وإما بأيدي المسلمين؛ فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون، ولا يتأتى لعاقل أن يقول؛ لا يُقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة، نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما حصل منها عدم أو كالعدم، والله أعلم)( ). وواضح من كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى تنصيصه على المفسدة العظيمة التي لأجلها جوَّز قتل الترس، وهي استيلاء الكفار وعلوهم على الأمة، وهي أصل المفاسد - كما أشرنا قبلا - فينتج من ذلك؛ "ذهاب الترس والإسلام والمسلمين"، إذ بعلو الكفار وسيطرتهم على الأمة صارت الأمور كلها بأيديهم، ومعلوم لدى كل أحد شدة وحرهم ووغرهم على الإسلام والمسلمين، وهم يتربصون بهم الدوائر، حيث لن يرضوا من الأمة بأقل من ارتدادها ارتدادا كاملا عن دينها ونبذها لشريعة ربها، سالكين في سبيل تحصيل ذلك كل ممكن ترغيبا وترهيباً وكيدا ومكراً وتلبيسا وتدليساً. قال الله تعالى: {إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ} [الممتحنة: 2]، وقال سبحانه: {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ} [البقرة: 120]، وقال سبحانه وتعالى: {وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217]، ونظائر هذه الآيات كثيرة معلومة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (وإن دعت ضرورة إلى رميهم؛ بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال، وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم؛ فوجهان....والثاني؛ وهو الصحيح المنصوص وبه قطع العراقيون، جواز الرمي على قصد قتال المشركين ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان، لأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام، ولا يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكليات)( ). وقال الغزالي رحمه الله: (أما الواقع في رتبة الضرورات؛ فلا يبعد في أن يؤدي إليه اجتهاد، وإن لم يشهد له أصل معين، ومثاله؛ إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا، وهذا لا عهد به في الشرع، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا، فيجوز أن يقول قائل؛ هذا الأسير مقتول بكل حال، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأنا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل، كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل)( ). وله في هذا الموطن كلام مسهب قيم، ولولا خشية الإطالة لنقلناه بكامله، فليراجع فإنه مهم في تصوير المسألة. كما وردت بعض العبارات التي أطلق فيها القول بالخوف على المسلمين ودفع الضرر عنهم وكف فساد الكفار للدين والدنيا من غير تفصيل لحقيقة هذا الخوف والضرر والفساد، ولكن لا شك أن أول ما يدخل فيها؛ هو غلبة الكفار للمسلمين وقهرهم إياهم، وتبديلهم لشرائع الإسلام، واستباحتهم لدمائهم، وانتهاكهم لأعراضهم، وسلبهم لأموالهم، فهذه أعظم المفاسد وأمهات المضار التي يُخاف على المسلمين من الابتلاء بها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: (فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يُقتل به لأجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره، كان ما يفضى إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التى لا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذى لا يندفع إلا بذلك؛ أولى)( ). وقال أيضا - وقد نقلناه سابقا -: (وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر اذا لم يقاتلوا؛ فإنهم يقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم)( ). وقال أيضاً: (وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء؛ فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر، فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يُفضي إلى قتل أولئك المُتترس بهم جاز ذلك)( ). وقال ابن مفلح الحنبلي: (وإن تترسوا بمسلمين رميناهم بقصد الكفار إن خيف علينا فقط، نص عليه، وقيل؛ وحال الحرب، وإلا حرم)( ). بل قد ذكر بعض الفقهاء - وأكثرهم من الأحناف -؛ أن رمي حصون الكفار بالمنجنيق ونحوه مما يعم به الهلاك جائز، وإن كان بينهم مسلمون، حتى لا يؤدي الكف عنهم لأجل ذلك إلى تعطيل الجهاد المأمور به شرعاً، وحتى لا يتخذه الكافرون ذريعة يمتنعون بها عن غزو المسلمين لهم، وظاهر كلامهم هنا؛ أن هذه الصورة أكثر ما تكون مفترضة في جهاد الطلب. قال الإمام الكاساني رحمه الله: (ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى والتجار؛ لما فيه من الضرورة، إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر، فاعتباره يؤدي إلى انسداد باب الجهاد)( ). وقال الإمام السرخسي رحمه الله: (ولكنا نقول؛ القتال معهم فرض، وإذا تركنا ذلك لِما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم، ولأنه يتضرر المسلمون بذلك، فإنهم يمتنعون من الرمي لما أنهم تترسوا بأطفال المسلمين، فيجترؤن بذلك على المسلمين، وربما يصيبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمين، والضرر مدفوع)( ). وأقوال العلماء في هذا كثيرة، ومعظمها يدور حول ما نقلناه. وعلى كل حال فيمكن تلخيص ما ذكروه إجمالاً من الضرر الذي بسبب خوف وقوعه جوَّزوا رمي الترس في النقاط التالية: الأولى: خشية استيلاء الكفار على ديار المسلمين وتسطلهم عليهم. الثانية: أن غلبتهم على ديار المسلمين تقود إلى إفساد الدين والدنيا، وتحت هذا من أنواع المفاسد وصورها ما لا يحصى. الثالثة: في الكف عن رميهم لأجل من بينهم من المسلمين تعطيل لفريضة الجهاد. الرابعة: أن الكفار إذا علموا بكف المسلمين عن رميهم لأجل من يُوجد بينهم من المسلمين؛ اتخذوا ذلك ذريعة لحفظ أنفسهم ومنع المسلمين من قتالهم. وكما نرى فإن بعض هذه الصور يختص بجهاد الدفع، وهو آكد وأعظم، وبعضها يمكن أن يكون في الدفع والطلب معاً. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مفرقاً بين قسمي الجهاد، ومبيناً كون جهاد طلب أعظم أهمية وأكثر تأكداً من جهاد الطلب: (وأما قتال الدفع؛ فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده)( ). وقول شيخ الإسلام رحمه الله في وصف العدو الصائل بإنه "يفسد الدين والدنيا"؛ إنما هي صفة كاشفة وليست مقيِّدة، بمعنى أن كل عدو صائل يعتبر مفسداً للدين والدنيا، ولا يمكن أن تنفك هذه الصفة عنه طرفة عين، فيترتب عليه ما ذكر من الحكم - وهو وجوب دفعه بالاتفاق - وهذا هي حقيقة كل الأعداء الذين صالوا على ديار المسلمين - قديماً وحديثاً - مما يجعل إنكار هذا الأمر أو المجادلة فيه هو من قبيل التنكر للمحسوسات والقطعيات. القضية السادسة ما مدى تحقق كل أو بعض الأضرار التي نص الفقهاء عليها في واقعنا وساحات الجهاد المعاصرة؟ مما لا شك فيه؛ أن أضرار تسلط الكفار على بلدان المسلمين شرقاً وغرباً قد بدت جلية يراها الأعمى فضلاً على البصير، وأن شرهم المستطير قد نال كل أبواب الشريعة ولحق سائر فروعها وأصولها - تحريفا وتزييفا وهدماً وتعطيلاً، وقتلا وتشريداً، ونهباً وسـلباً - فكم من بلدان المسلمين التي كانت قلاع حق ومنارات علم وحصون عدل، صارت بعد تسلط الكفار عليها وغلبتهم لأهلها؛ ديارَ كفر ومصادر شر ومنابع فساد وإفساد؟ فما بقي فيها من الإسلام إلا آثاره الباكية، والتي دلت على أن تلك الديار كانت يوما ما تحت سلطان الإسلام وحكمه، كما هو اليوم في الأندلس المنسية – أسبانيا - وفي فلسطين المثخنة وكثير من الجمهوريات السوفييتية وتركستان الشرقية وغيرها كثير. هذا سوى البلدان التي علاها الحكام المرتدون، ونُصِّبوا على أهليها، واستئصلوا شأفة الشريعة فيها وأقاموا بدلا عنها النظم والقوانين التي لا يماري في مناقضتها للشريعة واصطدامها مع قواعدها ومضادتها لفرعياتها إلا جاهل غبي أو منافق غوي. وما مُسخت صورة تلك الدول وانسلبت هويتها الإسلامية إلا بعلو الكفار وقهرهم لأهلها وإجراء أحكامهم وعقائدهم وتصوراتهم وأفكارهم ومناهجهم وعاداتهم وأعرافهم على الساكنين فيها، حتى نشأت أجيال لاتكاد تعرف من الإسلام شيئاً إلا اسمه. بل انقلب الحال في كثير من تلك البلدان وغيرها؛ إلى أن أصبح أهلوها هم أشد عدواة للإسلام وأهله من اليهود والنصارى، وأعظم تنكيلا بالمسلمين وقهرا لهم من أعدائهم الأولين الذين داهموا تلك الديار بجيوشهم الجرارة. بل لا ينبغي للمسلم أن يذهب بعيدا في ذلك ولا أن يضرب بعقله في أعماق الزمن ليتلمس هذه الحقيقة ويبحث عنها بكلفة وعنت، وليلتفت لفتة قصيرة إلى أفغانستان، وليقارن بين حال مدنها وسكانها - لا سيما كابول - يوم أن كانت تحت حكم إمارة أفغانستان الإسلامية وما آلت إليه اليوم، وهي تئن تحت وطأة قوات الصلبان وأعوانهم العُبدان، والأمر في ذلك لم يستغرق أكثر من أربع سنوات. ولا يظنن ظان أن الأمر مقتصر على الإفساد الأخلاقي ونشر الإباحية والفجور والعهر فحسب، فمع عظم هذا الخطر وشدته، إلا أن الأدهى والأمر هو إنشاء جيل بل أجيال تتربى على الإعجاب العميق والتبعية التامة لأولئك المحتلين الكفرة، والافتتان بهم في عقائدهم وأفكارهم وطبائعهم، والتحلل والتنصل والتنكر لكل ما له صلة بالإسلام، بل ونصب العدواة له، وما أكثرهم اليوم لا كثرهم الله. ولهذا فإننا نرى أن "عملاء الصليب" ووكلاءهم القائمين على حمايتهم بالحديد والنار ونشر أفكارهم عبر وسائل الإعلام المتنوعة؛ هم أخبث طوية وأشد رزية على الإسلام والمسلمين من سادتهم الذين يمدونهم ويوجهونهم ويقفون وراءهم، فكيف نشأت هذه الأجيال، وكيف تربى هؤلاء المجرمون لولا غلبة الكفرة وتمكنهم من مقاليد الحكم وتوليهم لتسيير الأمور حسب ما يرون ويريدون؟ فماذا يُرتجى من قوم أخبرنا الله عن مكنونات صدورهم وخبايا نفوسهم وأنهم: {لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ * هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [آل عمران: 118 – 119]، {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً} [النساء: 27]. فما ينبغي للمسلم الصادق المستبصر؛ أن يماري إطلاقاً في قيام عظائم المفاسد وفدائح المضار وكبائر الرزايا من جراء تسلط الكفار على ديار المسلمين، سواء تسلطاً مباشراً؛ كما هو الحال في الديار التي داهمتها الجيوش الكافرة السافرة، أم كان تسلطهم عبر وكلائهم وعملائهم الذين يسيرون وفق خطط مرسومة وخطوات محددة لسلخ الأمة عن دينها وإقصائها عن شرائعها وتمهيد الطريق أمام أبنائها لرفع لواء المحاربة لربها ودينها. فما من طامة يُخشى على المسلمين منها، وحذرت الشريعة من الوقوع فيها، وحضت على تجنبها؛ إلا وقد ضربت بجذورها في بلدان المسلمين. وإن أكبر عبرة أقامها الله للناس تنادي عليهم قروناً طوالاً؛ هي اقتطاع دولة كانت أزهى وأبهى وأغنى ديارهم وأحصن ممالكهم، ألا وهي الأندلس، حتى نسيها المسلمون وغابت عن ذاكرتهم وكأنها لم تكن يوماً تشع بنور العلم وتغص بجيوش الفتوحات. ومثلها الحال في فلسطين؛ حتى سُلب اسمهما - أو كاد - كما سلبت أرضها وحكمها، وصار جزء كبير منها يُسمى "إسرائيل". وهذا ما سيكون في أفغانستان والعراق وغيرها من بلدان المسلمين إن لم يُتدارك الأمر. فالإطالة في تقرير هذه الحقائق ومحاولة إثباتها وإقامة الأدلة عليها؛ كتحصيل حاصل، ولكننا في زمن "السفسطات" والمجادلة في القطعيات، وإنكار الشواهد البينات الجليات، فهذه الجيوش المحتلة وأعوانهم المرتدون؛ هم عدو صائل لا ريب فيه، وهم مفسدون للدين والدنيا - ظاهرا وباطناً - ومهلكون للحرث والنسل. فعلى مستوى تربية الجيل؛ فهم الذين يقومون بإنشاء أجيال محادة ومشاقة لله ولرسوله، وإن كانوا يتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا، وقد تشربت قلوبهم وعشعشت في عقولهم الأفكار الردية والمناهج الكفرية والمذاهب الشيطانية باسم "الحضارة" و "التقدم" و "الرقي". فمن أين جاء "علاوي" و "الجعفري" و "كرزاي" و "عباس" و "مبارك" و "القذافي" وغيرهم من حثالة الحكام المرتدين وجنودهم المتجبرين؟ ومثلهم من يسمونهم بالمفكرين المتنورين الذين توغلوا وتغلغلوا إلى أعماق الدين، ليزلزلوا أركانه ويبثوا سمومهم وأفكارهم التشكيكية في قواطعه وأصوله، ويلبسوا على الناس دينهم الحق، ويصيروه مرتعاً مباحاً لكل مارق زنديق لا حسيب عليه ولا رقيب. وعلى مستوى العقائد؛ هم الذين يعززون طرائق الشرك كلها - عبادة وتشريعاً وحكماً - وينشرونها بسبل شتى، ويرصدون عليها الملايين من الأموال، ويُسخرون لها جيوشهم وقواتهم وإمكاناتهم بلا عد ولا حد. وفي المقابل؛ يوصدون أبواب العلم التي تكشف للناس الحقائق وتعرفهم بشريعتهم، في حين تفتح الأبواب على مصارعها لأهل البدع والفرق الضالة، بل وأهل الزندقة والإلحاد، وتقويها وتدعمها وتشجعها وتطور أفكارها. وما أمر الهند وما وُلد فيها وترعرع في كنفها من أمثال تلك الفرق على أيدي الأنجليز ببعيد، والتي ما زالت الأمة تعاني من شرورها وتصارع أفكارها، وما تزداد تلك الأفكار إلا عتوا وقوة وتطوراً. وعلى مستوى الحكم؛ فعلى أيدي تلك الدول المحتلة وتابعيها وعبيدها؛ أُقصي الإسلام تماماً من الحكم وغُيرت مناهجه وبُدلت أحكامه وسُلطت القوانين المستوردة على رقاب الناس، تحكمهم في الدماء والأموال والأعراض، حتى صيغت نفسية المرء المسلم على عدم استشعار عظمة هذا الأمر. واستمرأ الناس تلك الحياة واعتادوها، وألفوا المتناقضات، فلا غرابة أن يكون أول عبارة في دستور تلك الدول المتمسلمة؛ "أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، وأن تكون باقي نقاطه ومواده لا تجعلها حتى في آخر القائمة من حيث التطبيق والتنفيذ والتوقير، بل هي حرب على أحكامها ونسف لمبادئها وسلخ لأهلها من كل قيمها وآدابها وأخلاقها. وعلى مستوى الأخلاق؛ فإن التحلل والإباحية والفجور والسفور والخمور والخلاعة والتخنث؛ هو شعار الحضارة وعنوان الرقي وعلامة التقدم، وما عداها فهو الجمود والخمود والركود والتخلف والتطرف، وهو ما تقوم عليه جميع وسائل الإعلام، وهو عمودها الفقري الذي تعتمد عليه، ودائرتها الموحدة التي تشترك فيها، ومصدرها الأول الذي تقتات منه، والتي فعلت الأفاعيل في عقول ونفوس نشء المسلمين بصور عديمة السبق في التاريخ. فصار كثير من نساء المسلمين وبناتهم؛ نهبة سائغة لأخبث وأنجس الخلائق، ممن ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وعاد الكذب والغدر والخيانة والتحايل من سجايا القوم وطبائعهم. وعلى مستوى توقير الشرائع؛ فإن كل ما يتوقعه المرء ويخطر بباله من أساليب الكفر واحتقار الشرائع والاستهزاء بها؛ فهو شائع ذائع، بل ربما هو عند البعض معروف مألوف. وأقبحها وأوقحها وأشنعها وأبشعها؛ سب الرب سبحانه وتعالى وسب دينه العظيم ورسوله الكريم، والسخرية بالمصلين وهيئاتهم وهديهم، وبالمحتجبات، بل وكل مظاهر الالتزام والسنن الظاهرة، كل ذلك يتم في وسائل الإعلام بطرائق شتى وأساليب متنوعة، على مرأى ومسمع من الناس أجمعين. أما ما يحدث على سبيل القهر والقوة من تنكيل للمسلمين ومطاردة للصادقين وانتهاك سافر لأعراض الحرائر العفيفات في غياهب السجون؛ فالحديث عنه لا يسعه موطن كهذا، بل ولا تكفيه مجلدات ومصنفات، والعد في ذلك لا ينتهي والإحاطة، بتفاصيله لا يمكن، وعين المرء وقلبه - إن لم يصبهما العمى والعمه - دليله في ذلك، وصفحات الواقع شاهدة لمن أراد القراءة من غير تعمق ولا جهد. فمن الذي يقوم على كل ذلك؟ ومن الذي يمد هذه المنابع الفاسدة والمصادر الضالة ويغذيها ويقويها؟ ومن الذي يكمم أفواه المصلحين ويلاحق الصالحين ويزج بهم في غياهب السجون وينعتهم بأقبح وأوقح النعوت لينفر الناس عنهم ويحول بينهم وبينهم؟ ومن الذي يطارد ويشرد من أراد تغيير المنكر بيده وينكل به أشد التنكيل؟ ومن الذي ملأ قلوب الناس خوفاً ورعباً من محاولة دعم القائمين بالحق، المجاهدين في سبيل الله؟ فهذا وغيره كثير؛ يدلنا دلالة قطعية أن المفاسد والمضار التي ألمح إليها الفقهاء في مسألة التترس وجوَّزوا لأجلها رمي الترس - وإن أدى إلى قتل من يقتل من المسلمين - كلها قائمة وموجودة، شائعة ذائعة، تزداد يوماً بعد يوم، وتتنوع صورها حينا بعد حين، فلا تكاد تخبو نارُ رزية إلا وتأججت غيرها، والأعداء يذكونها بمكرهم، ويورونها بكيدهم، ويدعمونها بقوتهم، ويحفظونها بعملائهم. فالفقهاء جوَّزوا ذلك "خوف الضرر"؛ أي تفادياً لوقوعه، ودفعا له قبل حصوله، وأما اليوم فإن ذلك الضرر؛ واقع، قائم، موجود، مشهود، فالأمر انتقل من الدفع إلى الرفع، ومن خوف وقوع الضرر إلى السعي إلى إزالته والاجتهاد في استئصاله. فالعلة التي اتفق الفقهاء على جواز رمي الترس فيها؛ موجودة بلا شك، بل هي اليوم آكد وأقوى وأظهر، فهذا أمر لا بد أن يكون في الاعتبار ومعترف به بين سائر العاملين. إلا أن أخذ الحكم من كلام أولئك العلماء لا يتوقف عند هذ الحد، ولا يُحصَّل من هذه المقدمة فحسب، بل لا بد من النظر فيما ذكروا من الضوابط وبينوه من الحدود وراعوه من الأحوال والهيئات المؤثرة، حتى يوضع الحكم في محله الصحيح، ولا يقوَّل أولئك الأئمة ما لم يقولوا، أو ينسب إليهم ما لم يعتقدوا ويتبنوا، والله المستعان. وما يظهر لي - والله تعالى أعلم - فيما يتعلق بحالة الاضطرار أو خوف الضرر، الذي عُلق به الحكم - وهو جواز رمي الترس - يمكن أن يقسم إلى قسمين: الأول منهما: هو ما كنا نتحدث عنه وهو الضرر العام الشامل الكلي المتعلق بعموم تسلط الكفار على ديار المسلمين، وهذا يرتبط بأصل قيام الجهاد ضدهم، وهو من أهم أسباب تعينه في هذا الزمان، وهو نتيجة متحتمة ولازمة لغلبة الكافرين على بلدان المسلمين، والذي يعبر عنه بعض الفقهاء بإفساد الدين والدنيا. ويعضد هذا الأمرَ العام؛ وجوبُ استمرار الجهاد وعدم قبول أي بديل عنه، لأنه أمر شرعي مفروض أولاً، ولأن ما سواه من المسالك والطرق؛ إنما هي إطالة لعمر الفساد، ومنح الفرصة للكفرة في التمكين لأنفسهم ونشر سمومهم وقلب حياة المسلمين وصوغها حسب إراداتهم وميولهم الشهوانية. وأما القسم الثاني: من أقسام الضرر الواقع على المسلمين فهو ما يتعلق بكل عملية عسكرية على حدة، والتي تدخل في مجمل العمل الجهادي العام وتعتبر فرداً من أفراده وجزئية من جزئياته. وذلك يتطلب أموراً كثيرة؛ في تقدير الضرر، ومدى قوة تحققه من ضرب هذا الهدف على التعيين، وعن إمكانية إزالته بهذه الطريقة المعينة وانحصارها فيها، بحيث لا يتأتى التوصل إلى ذلك الهدف إلا بتلك الكيفية المحددة، وفي هذا تتعدد أوجه النظر وتختلف الاجتهادات. ولهذا فلا يكفي - فيما يظهر والله أعلم - التعليل بخوف الضرر العام الشامل الواقع من احتلال الكفار لبلدان المسلمين، واعتبار حالات وجود أفراد الاحتلال جميعها بين المسلمين هي من قبيل مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء، بل لا بد من النظر في كل حالة بعينها، وحصر المصالح المتوخاة من ورائها، ومعرفة مدى الأضرار الحقيقة التي يراد إزالتها من ضرب الهدف العسكري المقصود في تلك العملية، وذلك مع استحضار الضوابط والقيود التي ذكرها الفقهاء - والتي سنشير إليها في النقطة الآتية - قال الدكتور محمد خير هيكل: (المراد بحالة الضرورة التي تدعو إلى القتال؛ جرى التعبير في المراجع الفقهية عن حالة الضرورة، هذه بعدة صور منها؛ أن يهجم العدو على المسلمين، وأن يكون المسلمون في حالة التحام مع العدو في القتال، وأن يترتب على عدم القتال ما يخشى منه على المسلمين من الإحاطة بهم أو استئصالهم أو هزيمتهم أو كثرة في قتلاهم أو أي ضرر يلحق بهم، والذي أراه هنا أن حالة الضرورة التي تدفع بالجيش الإسلامي إلى خوض الحرب مع العدو على الرغم من استخدامه للدروع البشرية المعنية؛ يرجع تقديرها إلى صاحب السلطة تبعا لاختلاف الظروف والأحوال... فقد تكون الحرب ضرورة لا بد منها في حالة معينة، ولو كان الدرع البشري الذي احتمى به العدو يتكون من عدد كثيف من المسلمين سيتعرضون للهلاك من جراء تلك الحرب، وقد تكون الحرب في حالة أخرى ليست بهذه الدرجة من الضرورة؛ فيرى صاحب السلطة أن من المصلحة أن يلغي إعلان الحرب مع العدو أو يوقف استمرارها لمجرد أن العدو قد عمد إلى درع بشري خفيف فتحصَّن به... ولو كان هذا الدرع يتألف من فرد واحد من أهل الذمة أو من المستأمنين... بل حتى ولو كان هذا الدرع يتألف من أفراد العدو نفسه من النساء والأطفال)( ). القضية السابعة في الأحوال والشروط التي أجاز الفقهاء عند توافرها رمي الترس وربما لا يتنبه البعض للفرق بين هذه النقطة والتي قبلها، فيدمجهما معاً ويحسب أنهما شيء واحد. فالمسألة السالفة؛ هي فقط في بيان العلة أو السبب الذي يجوز لأجله رمي الترس، لا سيما موطن الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو ما إذا خيف على المسلمين الضرر من الكفار إن لم يُرم الترس. وأما هذه المسألة؛ فتتعلق ببيان الشروط والقيود التي يجب أن توجد - حسب كلام الفقهاء - لإجازة رمي الترس، فعندها لا يكفي أن يُقال؛ إذا خيف على المسلمين الضرر جاز رمي الترس هكذا بإطلاق، بل لا بد من انضمام قيود وضوابط بتوافرها وقيامها يكون "خوف الضرر" مؤثراً في الحكم. وتلك الشروط والضوابط ذكرها الفقهاء متناثرة - كلٌ حسب مذهبه - وليست أمراً متفقاً عليه بينهم، ولا هي منصوصة ومجموعة عند جميعهم، بل هي مستخلصة ومأخوذة من كلامهم المتعدد في هذه المسألة، إلا أنه يمكن إدراجها بشئ من التوسع في التسمية تحت عنوان؛ "الضرورة" أو "الحاجة"، بمعنى أن الخوف من الضرر الذي يُعد كالعلة لإثبات جواز الرمي؛ لا بد أن يكون مقيداً بحال الضرورة أو الحاجة، وفي تحديد حقيقة الضرورة والحاجة تختلف عبارات الفقهاء كما أشرنا. فمن ذلك: - الأول؛ أن يكون رمي الترس حال التحام القتال: وهي صورة من صور الضرورة التي ذكرها الفقهاء، وإنما ذكروها لأنها من الحالات الشائعة، ولهذا فهي حكاية حال وبيان ظرف أقرب من كونها شرطاً مقيِّداً، ومع ذلك فلا بأس من ذكره لظهور احتمال الشرطية في عباراتهم الآتية، وتعبيرهم بعبارة؛ "التحام الحرب"، أو "التحام القتال"، هو أعم من حصره في التحام الصفوف، لأن القتال قد يكون بالرمي البعيد - كما هو الحال في المنجنيق عندهم وبالمدفعية الثقيلة في زمننا - ولهذا فإن من صور التحام القتال أو الحرب؛ هو تبادل القصف الثقيل بين المجاهدين والكفار، مما قد يلجئ الكفار أثناء القصف لجمع عدد من المسلمين الأسارى أو غيرهم في مراكزهم، ووضعهم بينهم، ليكف المجاهدون عن قصفهم. قال الإمام النووي رحمه الله: (فرع؛ لو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم نظر... وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال، وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم؛ فوجهان...)( ). وقال الإمام الشافعي رحمه الله: (ولو تترسوا بمسلم؛ رأيت أن يكف عمن تترسوا به، إلا أن يكون المسلمون ملتحمين فلا يكف عن المتترس، ويضرب المشرك، ويتوقى المسلم جهده)( ). وقال ابن قدامة رحمه الله: (وإن تترسوا بأسارى المسلمين أو أهل الذمة؛ لم يجز رميهم إلا في حال التحام الحرب والخوف على المسلمين، لأنهم معصومون لأنفسهم، فلم يبح التعرض لإتلافهم ضرورة، وفي حال الضرورة؛ يباح رميهم، لأن حفظ الجيش أهم)( ). - الثاني؛ ومنها أن لا يمكن التوصل إلى الكفار إلا برمي الترس: بمعنى أنه لا طريق لقتال الكفار وكفهم إلا عبر مَن تترسوا بهم من الأسارى المسلمين، أو لا يمكن فتح هذا الحصن إلا برميهم بما يعم به الهلاك - من منجنيق أو نحوه - وكل ذلك مضبوط؛ باتقاء إصابة الترس قدر الإمكان. وقد مر بنا قول الإمام القرطبي رحمه الله: (قلت: قد يجوز قتل الترس، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، فمعنى كونها ضرورية؛ أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس). وقال ابن مفلح رحمه الله: (وإن تترسوا بالمسلمين؛ لم يجز رميهم كأن تكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، أو من أمن من شرهم، إلا أن يُخاف على المسلمين، مثل كون الحرب قائمة، أو لم يُقدر عليهم إلا بالرمي فيرميهم، نص عليه للضرورة)( ). وقال شيخ الإسلام رحمه الله - وقد مر -: (ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يُفضي إلى قتل أولئك المُتترس بهم؛ جاز ذلك، وإن لم يُخف الضرر، لكن لم يُمكن الجهاد إلا بما يُفضي إلى قتلهم؛ ففيه قولان). وقال أيضا: (فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد؛ مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره؛ كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك، ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك؛ أولى)( ). - الثالث؛ ومنها أن يتحاشى الرامي ضربَ الترس قدر الإمكان ويبذل لأجل ذلك قصارى وسعه وغاية جهده: كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: (ولو تترسوا بمسلم رأيت أن يكف عمن تترسوا به إلا أن يكون المسلمون ملتحمين، فلا يكف عن المتترِس، ويضرب المشرك ويتوقى المسلمَ جهده). وقال الإمام النووي رحمه الله: (... والثاني - وهو الصحيح المنصوص وبه قطع العراقيون -؛ جواز الرمي على قصد قتال المشركين، ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان). وقال الشربيني الشافعي رحمه الله: (... وإلا بأن دعت ضرورة إلى رميهم؛ بأن تترسوا بهم حال التحام القتال، بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم؛ جاز رميهم حينئذ في الأصح المنصوص، ويقصد بذلك قتال المشركين، ونتوقى في المسلمين وأهل الذمة بحسب الإمكان)( ). - الرابع؛ ومنها أن يقصد الرامي برميه الكفار: بمعنى أن تكون نيته متوجهة لرمي الكفار دون المسلمين، لأنه إن لم يمكن تحاشي ضرب الترس - عملاً وفعلاً - فقد أمكن ذلك قصداً ونية، والميسور لا يسقط بالمعسور. قال الإمام السرخسي رحمه الله: (... إلا أن على المسلم الرامي أن يقصد به الحربي، لأنه لو قدر على التمييز بين الحربي والمسلم فعلا كان ذلك مستحقا عليه، فإذا عجز عن ذلك كان عليه أن يميز بقصده، لأنه وسع مثله)( ). وفي "البحر الرائق"( ): (... لكن نقصد الكفار بالرمي دون المسلمين، لأنه إن تعذر التمييز فعلا فقد أمكن قصدا، والطاعة بحسب الطاقة). وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين؛ جاز رميهم لأنها حال ضرورة، ويقصد الكفار)( ). وقال البهوتي رحمه الله: (... إلا أن يخاف علينا من ترك رميهم فقط؛ فيرميهم، نص عليه للضرورة، ويقصد الكفار بالرمي، لأنهم هم المقصودون بالذات)( ). وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (فإن الأئمة متفقون؛ على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار)( ). - الخامس؛ ومنها أن يقطع أو يغلب على الظن حصول المصلحة المرجوة برمي الكفار، وإن أدى إلى قتل الترس، وهي دفع ضررهم وكف أذاهم عن المسلمين ومنع استيلائهم على بلادهم: بمعنى؛ أن قتال الكفار مع إفضائه إلى قتل من تترسوا بهم من المسلمين يقود ويؤدي إلى حصول تلك المصلحة. كما قال الإمام القرطبي: (ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا). وإنما قلنا؛ "أو بغلبة الظن"؛ لأن تقدير ذلك راجع إلى الاجتهاد والنظر والتحري، وكل ذلك موجبٌ لحصول الظن الغالب، وسائر المسائل الاجتهادية إنما تكون كذلك. - السادس؛ ومنها أن تكون المصلحة المرجوة آنية حالية، وهو أمر زائد على أصل حصول المصلحة: بمعنى أن الأمر لا يحتمل تأخير رميهم والتأني في ضربهم لفوات المقصود بذلك. فأما مع إمكان التأجيل والقدرة على التريث في رميهم بما يحصل به الغرض ويتأتى معه المطلوب؛ فينبغي الكف عنهم، حقناً لدماء المسلمين، وجمعاً بين الأمرين - وهما دفع ضرر الكفار ورفع أذاهم والحفاظ على من بأيديهم من الأسارى أو من كان بينهم من التجار - قال الإمام النووي رحمه الله: (لو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم؛ نظر إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض عنهم؛ لم يجز رميهم)( ). - السابع؛ وهو أن لا يمكن التوصل لفتح الحصن أو كسر شوكة الكفار المتترسين إلا بما يعم به القتل - كالتحريق والتغريق والرمي بالمجانيق ونحوها مما قد يشمل استعماله مَن معهم من المسلمين -: قال ابن قدامة رحمه الله: (فإن كان فيهم مسلمون، فأمكن الفتح بدون ذلك، لم يجز رميهم، لأنه تعريض لقتلهم من غير حاجة، وإن لم يمكن بدونه جاز، لأن تحريمه يفضي إلى تعطيل الجهاد)( ). هذا والذي يجمع كل هذه الشروط والضوابط التي ذكرها الفقهاء متفرقة في مواطن شتى؛ هو قول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]. فالجهاد وإن كان مأموراً به أمراً مؤكداً - سواء في حالة الحاجة أو الضرروة - فإنه لا يلزم منه عدم مراعاة حرمات الدماء قدر الإمكان، ولا يزيل وجوب الموازنة الشرعية الصائبة بين حالة الضرورة الحقيقية القائمة وبين سفك دم للمجاهد مندوحة عن الإقدام عليه، فالجهاد لا يمنع التحري والحيطة واختيار الأوقات والأماكن والأحوال التي يحصل بها المقصود ويتوصل بها إلى المطلوب مع صيانة الدماء المحرمة شرعاً. وحالة التترس التي ذكرها الفقهاء؛ إنما هي حالة استثنائية خارجة عن الأصل، فيُضيَّق فيها زماناً ومكاناً وصفة - قدر الإمكان - ويُستمسك بالأصل حسب القدرة، وهذا ما يُستنتج من القيود المستخلصة من كلام الفقهاء، وهو أمر لا ينبغي أن يُختلف فيه أصالة؛ كقاعدة عامة كلية مُسلَّمة، وإن وقع الاختلاف في كيفية التطبيق ومدى توافر هذه الشروط أو انعدامها في الحالة المعينة التي يُراد إنزال الحكم عليها، وهو ما تتفاوت فيه التقديرات وتختلف الأنظار. ومِلاك ذلك كله؛ التقوى وبذل الجهد في التحري والاحتياط والدقة في النظر والتدقيق في كل حالة بحسبها، والتأمل في تفاصيلها، وعدم الاعتماد على الحكم الكلي العام ليكون مسوِّغا لكل عملية. والخلاصة في هذه المسألة الشائكة يمكن تلخيصها في عدة نقاط: - الأولى؛ أنه يصعب تحديد صور التترس المعاصرة وحصرها في حالات معينة محدودة كالتي ذكرها الفقهاء قديماً: لا سيما مع وجود العدو وسُكناهم بين المسلمين، وإقامتهم لمعسكراتهم ومراكزهم وقواعدهم في أحيائهم، وتنقلهم في طرقاتهم، وتعاملهم معهم، واختلاطهم بهم اختلاطاً شبه متكامل، وغدت المدن والقرى والأسواق المأهولة بالسكان؛ هي أهم ساحات معاركهم ضد المجاهدين - قصفاً واشتباكات وكمائن - وأصبحت مطارداتهم للمجاهدين واعتقالهم لأهليهم ومناصريهم لا يكاد ينفك عنها مكان ولا ينقطع زمان، مع أن أغلب الأسلحة المستخدمة من قبل المجاهدين ضد أعدائهم هي مما يعم به القتل غالباً، لقلة وضعف أو انعدم تأثير ما سواها في العادة. وأما صورة التحام الصفوف والقتال وجهاً لوجه والاصفطاف لذلك؛ فهذا وإن كان يقع شبيهه بين الحين والحين في الغارات الخاطفة أو الكمائن التي ينصبها المجاهدون عند توفر الفرص، إلا أنها لم تعد بتلك القوة التأثيرية على الأعداء المحتلين وأعوانهم، وذلك لتحصنهم المحكم في أعماق قواعدهم ومراكزهم. وهذه الصفات والأحوال تعطي تصوراً جديداً لتنوّع حالات التترس الحديثة، ربما لم يفترضها الفقهاء بهيئاتها الطارئة، بناء على ما عاينوه من أنواع الأسلحة المستخدمة في عصورهم، وأقصاها المنجنيق وتعميم الحرق بالنيران والإغراق الشامل، كما أن الأسلحة التي كان يستخدمها أعداؤهم تكافئ نوعاً ما الأسلحة التي بأيدهم. وأما في المعارك الضارية التي تشهدها ساحات الجهاد اليوم - لا سيما في العراق وأفغانستان - فهي في وضع مختلف اختلافاً كبيراً في كثير من صورها وظروفها، هذا مع أن المجاهدين قد فُرض عليهم نوعية المعركة وساحاتها، وربما اختيار الوقت المناسب لبعض عملياتها، والله المستعان. قال الدكتور محمد خير هيكل: (ومن الصور الحديثة التي تأخذ حكم التترس؛ أن يعمد الخصم إلى مقر قيادته أو إلى المنشآت العسكرية الاستراتيجية عنده فيحشوها بالرهائن – مثلا - وذلك بقصد حماية هذه الأماكن، حتى لا تتعرض للضرب من قبل الطرف الآخر، وهكذا تكون الأسلحة الحديثة قد وسعت من مفهوم التترس، بل جعلت هذا المفهوم في صوره المعاصرة أقوى منه في صوره القديمة. ففي القديم كان الخصم المقاتل يحتمي بشخص ممن ينتمي إلى الطرف الآخر، يمسك به أمامه ليتفادى به ضربات خصمه، وكذلك بالنسبة للجيش المقاتل حين يقدم أمامه صفا من الأسرى الأعداء - مثلا - ليتلقى بهم ضربات السيوف أو طعنات الرماح وما إليها... ففي هذه الحال يمكن للطرف الآخر الذي يهمه أن لا يتعرض الترس الحي أو الدرع البشري عند خصمه للأذى؛ قد يمكنه أن يقاتل، ويتفادى ما أمكنه أن يصيب ذلك الترس أو ذلك الدرع البشري... أما اليوم مع الأسلحة الحديثة المتطورة... التي منها ما يحيل هدفه إلى كومة من رماد بما فيه ومن فيه، فإن التترس في صوره المعاصرة التي أشرنا إليها، من شأنه أن يُكره الخصمَ؛ إما على الكف عن فكرة القتال حرصا على حياة الدرع البشري، وإما أن يقبل بفكرة التضحية المحققة بحياة هذا الدرع، وإعلان القتال بالأسلحة التدميرية الشاملة... أو أن ينجر إلى حرب طويلة الأمد ضد الخصم، بأسلحة تقليدية قد لا يكون من مصلحته أن يخوض مثل هذا النوع من الحروب التي تَحرِمه من الاستفادة من أسلحته التدميرية الشاملة... وذلك بسبب حرصه على حياة رهائنه عند خصمه، والذين سيكونون من أولى ضحايا تلك الأسلحة التدميرية فيما لو أراد استعمالها... الأمر الذي يصعب عند هذا الظرف أن يَطرح هذه الفكرة على بساط البحث... ومن هنا؛ يكون التترس في صوره المعاصرة أقوى في تحقيق أغراضه من التترس في صوره القديمة)( ). بل قد طرأت بعض الصور العصرية، التي لا تقل أهمية وخطورة وتأثيراً في سير المعارك وترجيح كفتها عن مسألة التترس، وقد تأملت فيها كثيراً؛ فلم أر فارقاً مؤثراً يمكن أن يغير الحكم. وتلك الصورة هي القصف العشوائي الانتقامي على مساكن العوام الآهلة بالسكان وأسواقهم العامة المكتظة، وذلك إثر كل عملية يقوم بها المجاهدون على مركز من مراكز العدو، وهو أمرٌ نعيشه ويعيشه سائر إخواننا المجاهدين في الساحات، والشيء المقطوع به هنا؛ أن ترك قتال العدو وشن الغارت عليه تركاً كاملاً لأجل ذلك، يؤدي إلى زيادة تمكنه وتوغله وسهولة مطاردته وملاحقته للمجاهدين، فما يقال في مسألة التترس؛ يقال في هذه المسألة - سواء بسواء – - الثانية؛ أن الأضرار التي ذكرها الفقهاء عند تجويزهم لرمي الكفار مع مَن تترسوا بهم من المسلمين، هي اليوم أوضح ما تكون في ساحات الجهاد الكبرى وعلى جميع المستويات: حتى شملت الضروريات الخمس من جميع جوانبها، بل ما جاءوا بجيوشهم الجرارة إلا من أجل سلخ المسلمين من دينهم سلخاً كاملاً وطمس معالم الشريعة الإسلامية طمساً تاماً. وهذه الأضرار بعمومها وشمولها؛ تعد في قائمة الأهداف الكبرى التي دخل لأجلها الكفار ديار المسلمين واستولوا على أوطانهم، ولهذا فإن الأمر قد انتقل من حالة "خوف الضرر" إلى بذل الجهد والاستماتة في التضحية لأجل رفعه وتقليله، وتحول الأمر من دفعه إلى رفعه، ومن اتقائه إلى انتشاله. وهذا كله ليس مجرد افتراضات ذهنية وتحليلات عقلية، بل هي أمور بينة جلية، لا تخفى إلا على الأعمى، ولا ينكرها إلى جاهل مغمور في جهله أو مكابر مجادل في القطعيات ومُنكِر للضروريات. وعليه فإن المسلمين مطالبون بتقديم أقصى ما في وسعهم وطاقتهم من الجهد لإزلة تلك الأضرار التي تستفحل وتتفاقم وتتضاعف يوماً بعد يوم، وبه يتبين أن أصل الموجِب الذي جوَّز بسببه الفقهاء ضرب الترس؛ يعتبر قائماً ملموساً، فيبقى مع ذلك انضمام الضوابط والقيود التي نصّوا عليها، حتى تكتمل الصورة ويكون الموجِب مؤثراً تأثيراً مباشراً في إيجاد الحكم - وهو ما يأتي في النقطة اللاحقة - - الثالثة؛ ينبغي على المجاهدين النظر في كل عملية عسكرية سيقومون بها والتي يمكن أن تطال بعض المسلمين نظراً مستقلاً بها ومتوجهاً إليها وأن يدرسوها دراسة خاصة بها تُحيطها من جميع جوانبها، إحاطة كاملة شاملة: بحيث تشمل عدة أمور؛ - منها: أهمية ووزن الهدف المقصود - عسكرياً أو سياسياً أو معنوياً أواقتصادياً – - ومنها: اختيار المكان والزمان المناسبين لتلك العملية بقدر الإمكان، والاجتهاد التام في ذلك بحيث يُتحرى فيه البعد عن أماكن إقامة ومرور وحركة العامة من الناس، ويُتجنب أوقات تنقلاتهم وازدحامهم. - ومنها: الاقتصار على كمية السلاح أو العبوات التي تؤدي الغرض، وتنعدم معها أو تتقلل الإصابات في صفوف المسلمين، وهو أمر في غاية الدقة والأهمية. - ومنها: الموازنة الدقيقة الواقعية بين الضرر الخاص المتعلق بذلك الهدف، والذي سيُكف بضربه، وبين الضرر الذي سيقع على المسلمين الذين قد تشملهم العملية تبعاً، سواء من جهة عدد القتلى في صفوفهم، أو من جهة بقاء تأييدهم وتفهمهم لظرف العملية وأهمية المستهدف فيها، ونحو ذلك. - ومنها: أن يكون الوصول لذلك الهدف بغير هذه الطريقة مُتعذراً أو متعسراً، بحيث يستحيل أو يصعب معه التوصل إليه إلا عبر الوسيلة التي قد تؤدي إلى مقتل بعض المسلمين. - ومنها: منع القصد القلبي لقتل المسلمين، بحيث تتوجه النية والمطلب فقط إلى قتل من يُراد من الكفار، ويعزم بقلبه على عدم قصد قتل أحد من المسلمين في تلك العملية بعينها، لأنه إن تعذر ذلك بالفعل والعمل، فهو ممكن بالقلب والنية، وجِماع هذه الأمور كلها في قول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16]. وبهذا يظهر أنه لا بد من التحري والحيطة في كل عملية على حدة، واعتبار هذه الأمور وغيرها مما يمنع أصابة المسلمين أو يُضيق دائرة إصابتهم، وهو أمر مقصود ومطلوب شرعاً. كما نقلنا عن الغزالي رحمه الله قوله: (لأنا نعلم قطعا؛ أن مقصود الشرع تقليل القتل، كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل)( ). ولا يكفي أو يغني؛ إدراج تلك العملية ضمن "دفع الضرر" العام، الواقع من جرّاء الاحتلال، ومن ثَم إقحامها في حكم التترس بمجرد ذلك، ومن غير ضرورة أو حاجة خاصة جزئية متعلقة بها - وهذا أمرٌ يقدره ويحدده القادة الميدانيون الذين يعايشون حقيقة الساحات ويحتكون بالعدو في صور وحالات وأماكن متنوعة – فما من موطن أمكن فيه صيانة دم المسلم وتأتى فيه حفظه بطريقة أو بأخرى مع قيام الجهاد واستمراره على الوجه المطلوب المؤدي للغرض؛ إلا كان سفكه مُحرماً. ومن هنا فإنني أعيد وأذكِّر بما ذكرته آنفاً؛ من أن مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء إنما هي حالة استثنائية عارضة خارجة عن الأصل، ولذا فإن لها ظروفها وأحوالها وأحكامها الخاصة بها، وما ندَّ عن الأصل؛ يُقتصر فيه على حدوده وضوابطه من غير توسّع ولا استرسال، حتى لا ينقلب أصلاً، ومتى انقضت صورة الشذوذ، وأمكن الرجوع إلى الأصل والاستمساك به وجب ذلك، وهي داخلة في عموم القاعدة الفقهية المعروفة؛ "أن الضرورة تقدر بقدرها". فمتى التُزم بهذه الضوابط وما شاكلها من كل ما يحفظ دماء المسلمين ويقلل من إصاباتهم واستُفرغ الوسع فيها؛ فنرجوا أن لا يكون هناك بأس بالقيام بعمليات عسكرية، ولو قُتل فيها بعض المسلمين - تبعاً لا قصداً – كما نرجوا أن يكون هؤلاء المسلمون المقتولون؛ شهداء عند الله، لأنهم إنما قُتلوا لأجل الجهاد ودفع الضرر العام عن الأمة. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وقد اتفق العلماء؛ على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم، وإن لم يُخف على المسلمين؛ ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين؛ قولان مشهوران للعلماء، وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يُقتل شهيداً، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قُتل من المسلمين يكون شهيداً، ومن قُتل وهو في الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام؛ كان شهيداً). وهو كلام تكرر له مراراً فليراجع في موطنه. وكنت قد أرسلت سؤالاً إلى العلامة عبد الله بن قعود رحمه الله قبل تسع سنوات، حول بعض الصور المعاصرة، وعما إذا كانت داخلة في صور التترس التي يذكرها الفقهاء أم لا، فأرى أن أنقل السؤال وجوابه لتكميل الفائدة. (إذا أنشأ العدو معسكراته بين مساكن الناس، واضطر المجاهدون إلى تفجيرها بحيث يؤدي قطعاً أو بغلبة الظن إلى إصابة وقتل بعض المقيمين حول تلك المعسكرات، فهل هي من صور التترس التي ذكرها الفقهاء، علما أن تلك المعسكرات تكون غالباً بين الأحياء السكنية لتفادي ضربات المجاهدين؟). فأجاب بقوله: (الذي أراه - والله تعالى أعلم - أنها صورة من صور التترس، حتى لو لم يجبرهم على البقاء، وقد تكون المصلحة في ترك هذا حتى لا يؤدي [إلى] الضرر بالمسلمين، أو هناك طريقة حتى يخرج الأعداء من مكانهم، لكن يجوز أن يقصد بالقتل العدو فقط ويحتاط في عدم إصابة مسلم، والله أعلم). وقد نشرت هذه الفتوى من قبل في مجلة "الفجر" وعلى موقع "الجماعة الإسلامية المقاتلة"، وحينها كان الشيخ رحمه الله قد طلب عدم نشر اسمه، حفاظاً على نفسه من جلادي آل سعود. هذا ونسأل الله العظيم أن يعصم المجاهدين من الضلال، ويقيهم مزلات الفتن، وأن يجعلهم سبباً في صون دماء المسلمين وحفظ دينهم وأعراضهم وأموالهم، وأن يفتح لهم أبواب النكاية في أعدائهم، وأن لا يحوجهم إلى مضايق الأمور وحرج المشتبهات، وأن يملأ قلوبهم تقوى وورعاً وخشية له في السر والعلانية، وأن يصحح قصدهم، ويخلص نياتهم، ويصوِّب أعمالهم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكتبه راجي عفو ربه أبو يحيى، حسن قائد 6 / ذو الحجة / 1426 هـ |
|
#43
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
شبهة (جواز قتل معصومي الدم إذا تترس بهم العدو) رابط الموضوع : http://www.assakina.com/shobhat/shob...#ixzz22iXUILdX http://www.assakina.com/shobhat/shobhat2/5097.html الاستدلاَلُ على جَوازِ التَّفجير العامِّ برَمي التُّرس والرَّدُّ علَيه ويليه الجَوابُ الحاسِمُ لبَعض الشُّبَه القِتاليّ http://www.shobohat.com/vb/showthread.php?t=3637
__________________
أن الروافض والخوارج شر من وطيء الثرى أكره كل أهل البدع شيعه إخوان صوفية الخوارج القاعدة هم العدو الحقيقي للإسلام لإنهم مثل السوس ينخرون في ديننا ويقدموه ناقص حتى أن ألقى الله عز وجل سأدافع عن التوحيد والسنة واتباع نبينا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ http://www.youtube.com/watch?v=I_BsUerwWhM قال الإمام الآجري رحمه الله:[فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير!!!!!!]… قال سفيان بن عيينة:“ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر؛ إنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه، وإذا رأى الشر اجتنبه”. [حليةالأولياء-8/339] |
|
#44
|
|||
|
|||
|
[align=center]حياك الله أخي محسن المطيري .
يا اخي الكريم ... بالنسبة لقضية الإجتهاد ، فإنه لا يجوز لأي أحد أن يجتهد حتى أنا و أنت مالم يحصل شروط الإجتهاد . و أما قضية الذهاب للموت كما قلت ... ! فكلامك يا أخي خالف سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين . و إليك قصة أحدهم رضي الله عنهم : إنه الصحابي الكريم عمير بن الحمام الأنصاري -رضي الله عنه-، وقد شهد عمير غزوة بدر الكبرى مع الرسول (. وفي بداية المعركة وقف الرسول ( خطيبًا في الناس يحثهم على الجهاد، ويحرضهم عليه وعلى بذل النفس في سبيل الله، فقال: (لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه). فلما اقترب المشركون، قال (: (قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض). فقال عمير -رضي الله عنه-: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ فقال الرسول (: (نعم). فقال عمير: بخٍ بخ. فقال الرسول (: (ما يحملك على قولك بخٍ بخٍ؟) فقال عمير: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال له الرسول (: (فإنك من أهلها). فأخرج عمير من جعبة سهامه بعض التمرات، وأخذ يأكل، ثم قال لنفسه: لئن أنا حييت (عشت) حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة، فقام ورمى ما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. [مسلم]. فكان عمير -رضي الله عنه- بذلك أول شهيد للأنصار قتل في سبيل الله. ففعل الصحابي رضي الله عنه لم يقتصر على التمني ، بل ذهب و طلب الموت في سبيل الله .[/align] |
|
#45
|
|||
|
|||
|
[align=center]و عليكم السلام و رحمة الله و بركاتة أخي الكريم أبوبكر 110
و شكراً على مشاركتك الطيبة و كفيت و وفيت جزاك الله كل خير يا أخي الفاضل .[/align] |
|
#46
|
|||
|
|||
|
[align=center]يا أوراق مبعثرة لا أرك إلا أهل للجدال .
و هناك نوعين ممن يشاركونا الردود 1. من يرد و يشارك بعد أن يقرأ الموضوع أو الرد و يرده إلى المنبع الصافي الكتاب و السنة فيذعن للحق و يرضى به . 2. من يرد لمجرد الرد فقط و الإنتقاص من الإخوة و يريد أن يجادل فقط و يدافع عن رأيه ، و حتى لو كان مخالف للدليل الشرعي . و أنا لا أظنك تبحث عن الحق بقدر ما تبحث عن الجدال - هداك الله - ، فأنا من قبل وضعت رابط المناظرة أو الحوار الذي تم مع منتداكم بخصوص العمليات الإستشهادية و عدم جواز تسميتها بالإنتحارية و قد إتفق الشيخ أبوجهاد معنا بأنها ليست إنتحارية و لا يجوز إطلاق هذه الكلمة عليها . و أنت رغم هذا تنتصر لرأيك و تخالف الدليل الشرعي . فأنت تستحق بإمتياز صفة الجدال . و أنا أشك أنك قرأت كلام الأخ أبو بكر و تمعنت بالأدلة الشرعية التي ساقها في رده الطيب . و الله أعلى و أعلم .[/align] |
|
#47
|
|||
|
|||
|
[align=center]و بالنسبة للرابط الأول الخاص بـ " أوراق مبعثرة " فكله كلام لا يحتوي على دليل شرعي واحد .
و نحن نعلم أن قتل النساء و الأطفال و المسلمين لا يجوز ، و لكن هناك حالات خاصة و بالنص الشرعي و حسب أقل الضررين يكون قتل الترس أقل ضرر من أن نترك الكفار يتمكنوا في بلاد المسلمين، و لو أنهم تمكنوا فيها لقتلوا أمثال الترس أضعافاً مضاعفة و شردوا و أغتصبوا و فعلوا الأفاعيل . و أقول لك و كل من يقول بقولك إرجعوا لكلام الأخ أبو بكر ، فإن كلامه و الله لم يخلوا في جزئية من جزئياته من الدليل الشرعي. و أعيد و أقول : الكلام الذي في الرابط الأول يخلوا بالكلية من دليل شرعي واحد . و الرابط الثاني هو نفسه الأول . أما بالنسبة للثالث : فهو يحلل النصوص الشرعية و أقوال العلماء كما يحلو له . فهو يقول عن القرطبي رحمه الله : " وذلكَ إذَا كانَت المَصلحةُ ضَروريَّةً كُلِّيَّةً قَطعيَّةً " فأسأله من يحدد المصلحة و المفسدة في هذه الحالة ؟ أيحددها من يجلس على أريكته ؟ ! أم يحددها من يواقعون الحدث و يعايشون الواقع ؟ أكيد سيكون جواب كل ذي لب هو الثاني لأن أهل الجهاد أعلم بالمصالح و المفاسد لأنهم أهل الواقعة و هم من يعايشونها. و يقول يجوز قتل الترس في حالة واحدة إذا هلك جميع المسلمين إذ لم يقتل الترس ، و كأنه يقول لو هلك جميع المسلمين إلا واحد منهم لم يجوز قتل الترس !! و كلامه و إستدلاله بالأدلة و تحليله للنصوص في غير موضعه و أختم و أقول لإخواني و أخواتي القراء : عندكم مبحث أخينا أبو بكر 110 و عندكم روابط أوراق مبعثرة فأقرؤا كليهما و ستجدون بإذن الله من أقوى حجة بالدليل الشرعي . [/align] |
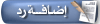 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| أدوات الموضوع | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
| لا نأخذ من الائمة فقه لعدة اسباب منها الجهالة والتقية والخرافات | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-21 07:02 PM |
link
تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية






